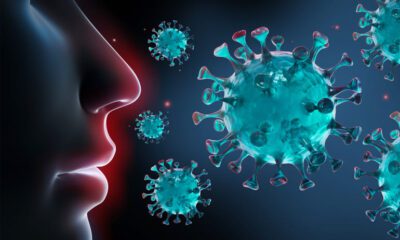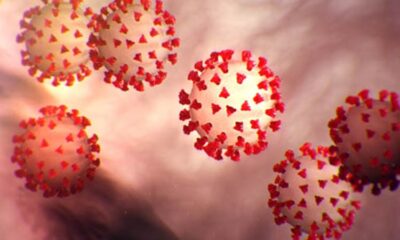مقالات وتقارير
هل يكون رمضاناً بلا تراويح ولا إفطار العائلة! ما سنشتاق إليه في زمن كورونا

انتشرت في الآونة الأخيرة -قبل بداية الكورونا- على السوشيال ميديا كلمات كثيرة عن مدى ملل الناس من حياتهم العادية -كما يُقال- عن مدى سوء الوضع في العالم وصعوبة العيش فيه، عن مللنا من يومنا العادىّ الذي ليس به جديد، ذهاب إلى العمل، ثم عودة إلى البيت، ومن البيت إلى العمل، ومن العمل إلى البيت مع بعض النزهات والخروجات البسيطة في بعض الأماكن العادية، مع لمة العائلة كل يوم جمعة، وكراهية الطلاب للمدارس والجامعات، وسوء المناهج والتنظيم، وطول المحاضرات، والملل منها، والشرود فيها، كل هذا وأكثر كان عادياً، مألوفاً، بل ومملاً.
ثم ظهر تريند معاكس يدعو إلى تقدير النعم المألوفة العادية، وأنه ينبغى على الإنسان أن يحمد الله على يومٍ عادى لم يحدث فيه شيءٌ جديد سوى أنّه مرّ عادياً كما يُقال. وما بين هذا وذاك، ظهر هذا الوباء المُخيف، “مستر كوفيد”، هذا الوحش المخيف الذى أخاف العالم أجمع، أفاقه، أقامه ولم يُقعده، ومعه بدأت تتغير مؤشرات الصحة والاقتصاد العالمية، معدلات الحياة والممات في العالم كله بظهور فيروس كورونا.
ثم بدأ الناس بالحنين إلى الماضي خوفاً من الحاضر، والاشتياق إلى ما كان بدلاً مما يكون، واشتقت أنا كذلك. اشتقت في زمن الكورونا، اشتقت لحضن أمي، وقبلة على رأس أبي، اشتقت لزيارةٍ من أختى المتزوجة حديثاً وزيارة إليها، اشتقت لأختي، اشتقت لعملي ومكتبي وكوب قهوتي الذي كنت أملّ منه كل صباح في السابق، اشتقت لأصدقائي في العمل، ومشقة الذهاب والإياب منه وإليه. اشتقت لصديقتي وعناقنا المطول الذي يبوح بالكثير والكثير، اشتقت لزيارة العائلة، لزحام الشوارع، لأُنس الليل، للمّة المُبهجة، لأفراح شارعنا، ومناسبات عائلتنا وأصدقائنا، اشتقت ليوم الجمعة كما اعتدناه، حيث لمّة العائلة وصلاة الجمعة، وأحاديثنا الجماعية المطولة التي تردّ الروح وتسترجع جميل الماضي وأُنس الحاضر، اشتقت لشارعنا، لم أكن أعلم أني أحبه بهذا القدر.
اشتقت إلى الأُنس، إلى الوَنَس، إلى الحياة، بكل ما اعتدناه فيها وألِفناه حتى ظنناه بجهلنا باقياً. اليوم نشتاق إليه، نشتاق إلى كل تلك النعم المألوفة، هل لا بد من زوال النعم حتى ندرك قيمتها؟ هل لا يأتي التقدير سوى بعد الفقد؟
صرت أخشى الأرقام مؤخراً، أكره سماعَها كلَّ يوم، صرت أكره السفر كثيراً، لأول مرة أحب البقاء في بلدي -رغم أن الخطر عنها ليس ببعيد- ولكنّي أخشى الاغتراب والمرض معاً. أخشى الزحام والأحضان، أخشى لقاء الأحبة، أخشى أن نكون معاً! من عدة أيام استيقظت باكراً على صوت أختى الصغيرة المتهدج بأنها لا تستطيع التنفس، ورغبتها في البكاء مما تعانيه من ألم، وقد كانت تعاني من دور إنفلونزا في الأساس، قلت لها: الأمر شديد؟ أوقظ أمي؟ حتى قالت لي: نعم. وما بين هلعي وهلع أمي المبدئي، وارتدائنا للكمامات والقفازات في بداية التعامل مع الأمر حتى نتأكد من شكوكنا أو ننفيها، وما بين رغبة أمي في التعامل هي معها خوفاً عليّ ورغبتي بالعكس خوفاً على أمي، المناقضة لرغبتنا معاً في الابتعاد عنها خوفاً من العدوى إن كان الأمر صحيحاً، قالت لي أُمي: الآن تذكرت قوله تعالى: “يَوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ”. وقفت مندهشة، الأمر جلل، هل هي تذكرة؟
اليوم رمضان على الأبواب، بعدما أُغلقت المساجد والكنائس، حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي، في مشهد مهيب لم نره من قبل بهذا السوء، اليوم اشتاق الناس للمساجد وقد كانت خالية من قبل، افتقد الناس صلاة الجماعة ويوم الجمعة، اليوم جميع الناس يريدون الحج والعمرة، رؤية بيت الله الحرام وما به من زحام وطواف وصلاة، واليوم أنا خائفة بشدة، خائفة أن نُحرم من صلاة التراويح في رمضان، من اللمّة على الإفطار، من عمرة آخر رمضان، من الخير كله والبركة كلها! أدعو الله أن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وألا يحرمنا فيه من فضله وخيره. وأن يرفع البلاء عن العالم أجمع، نحن ضعفاء جداً مهما بلغنا من قوة، وجهلاء جداً مهما بلغنا من علم يا الله.
اليوم أذكر من الماضي انتشار الأوبئة قديماً، خاصةً الطاعون، وقد كان يفتك بمن يُصاب به، فأُدرك أننا رغم كل شيء، وكل خوف وهلع، وكل افتقادٍ واشتياق مازلنا في نعمةٍ كبيرة، مقارنة بما هو أعظم في فترات الماضي، مازلنا نتمتع بالماء والكهرباء والأهل والوطن والأمان من الحروب، والسكن، والعمل، والدين، مازلنا في نعمة يجب تقديرها حتى لا نفقدها هي الأخرى، فلك الحمد يا الله على نعمٍ كانت ومازالت، لك الحمد، ولا يُحمد على مكروهٍ سواك.
مقال للكاتبة : أمينة محمود .